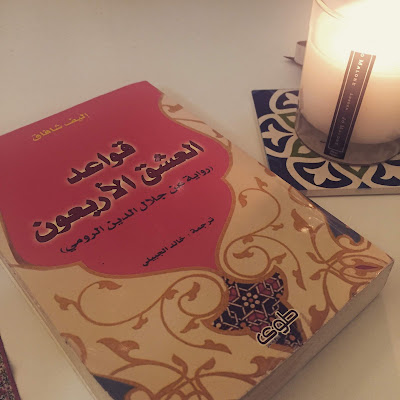رحلتي مع الماجستير

لم أكن أفكر في دراسة الماجستير أو أطمح لها، بالكاد كنت أتمنى إنهاء مرحلة البكالوريوس المتعبة جداً والتي دامت خمس سنوات. لكن فرصة دراسة الماجستير أتت في وقت كنت بحاجة فيه إلى أمر يجدد قدرتي على العطاء والإيمان الداخلي بوجود تلك القدرة بعد خمولها. أحببت أن أنوّه هنا في هذا الوقت بالتحديد أنه سيدور في ذهنك وفي ذهن أي شخص سوف يقبل على دراسة الماجستير أو ربما كل تجربة جديدة شيء من الخوف والتردد. عني شخصياً، لم أكن متيقنة من رغبتي الحقيقية في خوض تجربة الماجستير خاصةً أن البرنامج الذي تم قبولي فيه هو امتداد لتخصصي، فارتبط في ذهني حينها صعاب تجربتي السابقة بالتجربة القادمة، وكيف لي أن أواجه مجدّدًا ما كنت أهرب منه ذات يوم! البداية و قبول التحدي: كنت خائفة ومترددة، لدرجة أنني وضعت الانسحاب من القبول كأحد الخيارات المتاحة لهذه التجربة الجديدة. وبعد البدء المتردد، وجدت أن البداية لطيفة والدروس مقبولة نوعاً ما، والتقيت بزميلات لطيفات دار بيننا حوار عن مشاعرنا تجاه هذه التجربة، فقلت لهن بأنني سوف أخوض هذه التجربة مبدئياً لأجرب فقط وقد أنسحب. فأجابتني زميلتي بجملة قصيره قائلة: